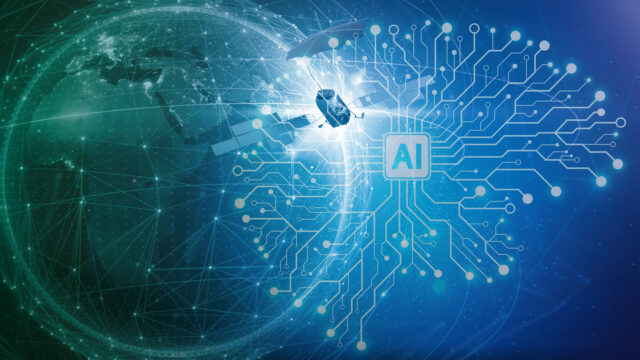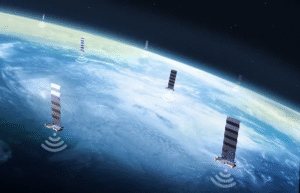من فيلم "نورة" السعودي الذي تم عرضه في كان
القاهرة – (علي عبد الرحمن)
في ممرات مهرجان “كان” السينمائي، حيث تلتقي العوالم البصرية وتتقاطع الألسن الثقافية ضمن مشهد دولي كثيف، تتسلل خطوات خليجية هادئة لكنها واثقة، تحمل في طيّاتها وعدًا بتغيير قادم.
لطالما بدا المشهد السينمائي العالمي بعيدًا عن تمثيلات منطقة الخليج، التي حُصرت طويلًا في قوالب نمطية وسرديات محدودة، غير أن التحولات المتسارعة، على المستويين المجتمعي والثقافي، دفعت بالسينما الخليجية إلى أن تعيد النظر في صورتها، لا كمُنتج محلي، بل كمشروع سردي يحمل طموحات عابرة للحدود.
ولم تعد هذه السينما محصورة في إطارها التجريبي أو محاولاتها المحدودة، بل باتت اليوم تبحث عن لغة خاصة بها، تتجاوز الصورة، وتنخرط في إعادة تعريف الذات الخليجية من خلال الفن السابع، بحثًا عن منصة عالمية تتيح لها التعبير عن رؤاها المتداخلة.
من الوثائقيات إلى الحكاية الملتهبة
في بداياتها، كانت السينما الخليجية بمثابة مرآة توثيقية للبيئة المحلية، حيث لعبت الكاميرا دور المؤرخ أكثر من الفنان، في البحرين والكويت، انطلقت التجارب الأولى خلال ستينيات وسبعينيات القرن العشرين، غالبًا ضمن مؤسسات رسمية أو قنوات تلفزيونية مغلقة، ما قيّد الخيال السردي، وأبقى السينما في إطار تقني بحت.
لكن مطلع الألفية الثالثة شهد بروز جيل جديد من المخرجين المستقلين، حملوا الكاميرا بوصفها أداة سرد لا أداة حفظ.
ومع اتساع الهوامش السياسية والاجتماعية، بدأت الأفلام الخليجية تتناول موضوعات كانت بالأمس القريب من المحرّمات: المرأة، الهجرة، التحولات الاقتصادية، الأسئلة الوجودية، وموقع الفرد داخل المجتمع.
وإن كانت البدايات تتّسم بالتحفّظ، فإن المسار السردي للسينما الخليجية بات أكثر نضجًا، قادرًا على إنتاج خطاب سينمائي متعدد الطبقات، بعيد عن الوعظ المباشر، وأقرب إلى المعالجة الإنسانية المفتوحة.
الإمارات: ريادة بنيوية في صناعة السينما
في المشهد السينمائي الخليجي، تبرز الإمارات كنموذج فريد من حيث التخطيط الاستراتيجي والبنية التحتية الثقافية، فقد اختارت الدولة منذ بدايات الألفية الجديدة أن تجعل من السينما ركيزة من ركائز مشروعها الثقافي الأوسع، فأسست لهذا الغرض مجموعة من المؤسسات والمهرجانات والمبادرات التي أعادت رسم حدود الممكن في الخليج.
لم يكن المسار سهلاً، لكنه كان منهجيًا، ومن مهرجان أبوظبي السينمائي، إلى مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للطفل، ومن لجنة أبوظبي للأفلام إلى برامج دعم المواهب الناشئة، كانت الإمارات تحفر عميقًا في الأرض الصلبة لتبني مشهدًا سينمائيًا لا يعتمد على الموهبة فقط، بل على التمكين المستمر والتكوين المستدام.
وقد أفرزت هذه الرؤية الطموحة عددًا من الأسماء البارزة، التي مثلت الإمارات في محافل سينمائية دولية، أبرزهم: نجوم الغانم، التي مزجت بين الشعر والسينما، وابتكرت لغة بصرية ذات نبرة وجدانية عالية، تستند إلى الحساسية الثقافية وتطرح قضايا وجودية بكثافة ناعمة،
عبدالله الكعبي، الذي أثار جدلًا فكريًا وجماليًا بفيلمه "عَلم"، والذي عرض في مهرجان برلين، كنموذج على الطموح الإماراتي في إنتاج سينما تنظر للعالم بعيون محلية لا تفقد عالميتها، نواف الجناحي، الذي ساهم في خلق بيئة سينمائية تدريبية وتنظيمية، مساهماً بذلك في تكوين جيل جديد من السينمائيين الإماراتيين.
ورغم غياب الأفلام الإماراتية عن قوائم المنافسة الرئيسية في مهرجان "كان"، إلا أن ما تحقق من بناء مؤسسي، وتكريس لدور الدولة الثقافي كراعٍ لا كمنتج فقط، يجعل من الإمارات ركيزة مركزية في تطور السينما الخليجية، ونقطة ارتكاز حقيقية لأي مشروع سينمائي عربي شامل.
السعودية: من العزلة إلى الحضور الفاعل
لعل تجربة المملكة العربية السعودية تُعد الأشد دراماتيكية من حيث التحوّل، فبعد عقود من غياب كامل لدور العرض، وانقطاع عن المشهد السينمائي العالمي، جاء قرار السماح بإعادة فتح صالات السينما عام 2018 بوصفه مفصلًا ثقافيًا وسياسيًا لافتًا.
ولم يكن الأمر مجرّد قرار تنظيمي، بل جاء ضمن رؤية ثقافية متكاملة، ترافق فيها الانفتاح الاجتماعي مع إعادة بناء قطاع ترفيهي متكامل. وسرعان ما برزت أسماء مثل هيفاء المنصور، التي دخلت تاريخ السينما العربية كأول مخرجة سعودية تحظى بعرض في مهرجان عالمي مثل "فينيسيا"، إلى جانب عبدالله آل عياف وماجد الراضي، وغيرهم ممن راكموا تجربة سردية ذات ملامح خاصة.
وفي عام 2022، كان لـ "Red Sea Fund" دور مهم في دعم الإنتاج العربي والأفريقي، حيث موّل 12 مشروعًا، بعضها يعود لمخرجين خليجيين، مما مكّنهم من ولوج منظومة الإنتاج العالمية، وتوسيع قنوات التوزيع، وفتح نوافذ جديدة أمام السينما السعودية للانخراط في المشهد السينمائي الدولي.
عُمان وقطر والبحرين: تجارب تنتظر نضجًا مؤسساتيًا
في الأطراف الأخرى من الخليج، تسير السينما بخطى متفاوتة، ففي عُمان، مثلًا، ظهرت محاولات فردية لافتة، من بينها ما قدّمه الدكتور خالد الزدجالي، الذي حاول أن يجمع بين الطابع السياحي والرؤية الاجتماعية، لكن غياب الأطر المؤسسية حال دون ترسيخ هذا التوجّه أو تطويره.
أما البحرين، التي كانت رائدة في التأسيس لتجربة خليجية مبكرة، فقد شهدت انحسارًا واضحًا، بعد أن تعثّر استمرار مهرجان الخليج السينمائي، نتيجة غياب الدعم المتراكم والإرادة المؤسسية.
أما قطر، فقد اتجهت إلى دعم السينما العربية والعالمية من خلال مؤسسة الدوحة للأفلام، والتي موّلت أفلامًا شاركت في مهرجانات مرموقة، لكنها حتى اللحظة لم تتمكن من بناء سردية قطرية خاصة ومتماسكة، تحمل توقيعًا بصريًا يمكن تمييزه، أو مدرسة سردية تعكس خصوصية الهوية الثقافية المحلية.
الهوية الخليجية: سرد يتجاوز الصحراء والنفط
أحد أكبر التحديات التي تواجه السينما الخليجية هو فكّ الارتباط بالصورة النمطية، التي ربطت الخليج بالصحراء والنفط والانعزال، فالمهرجانات الكبرى، وعلى رأسها "كان"، تبحث في الفيلم عن سردية متكاملة لبلد، لا عن صورة روتينية أو عرض فولكلوري.
في هذا السياق، يُعد فيلم "بركة يقابل بركة" لمحمود صباغ علامة فارقة، إذ نجح في تقديم قصة اجتماعية بسيطة على السطح، لكنها تخفي تشققات بنيوية عميقة، معتمدة على لغة بصرية مرهفة، تتجنب المباشرة والاستعطاف، وتتبنى مقاربة ذكية للواقع.
المرأة الخليجية خلف الكاميرا: وعي جديد وسرد مغاير
ليس من الممكن الحديث عن تحوّل السينما الخليجية دون التوقّف عند الحضور المتزايد للمرأة، ليس فقط كممثلة، بل ككاتبة ومخرجة وصاحبة مشروع سردي مكتمل، ولقد فرضت أسماء مثل هيفاء المنصور وريم المسافر ونجوم الغانم حضورهنّ بقوة في المشهد، عبر أعمال تعكس وعيًا نسويًا مختلفًا، يقدّم المرأة كفاعل سردي، لا كموضوع للشكوى أو الترحم.
وقد أسهم هذا الطرح في دخول أفلامهن إلى محافل دولية كبرى، في وقت يبحث فيه العالم عن سرديات نقدية تنطلق من الداخل، لا تُفرض من الخارج.
نحو خارطة سينمائية خليجية جديدة
الطريق إلى مهرجان "كان" ليس سهلًا، ولا يتم اختزاله بالإمكانيات المالية أو الطموح الفردي، بل يتطلب بيئة مؤسسية متكاملة، تشمل النقد، وورش كتابة السيناريو، ومراكز التدريب، ومنصات التوزيع، والمهرجانات المحلية القادرة على خلق حركة سينمائية داخلية، لكن ما تحقق حتى اللحظة يُعد مؤشرًا على نضج قادم.
فالسرد الخليجي خرج من النمطية، وبدأ يخاطب العالم بلغة السينما لا بلغة الشرح، وباتت الكاميرا ليست مجرد أداة تصوير، بل وسيلة للفهم، للتساؤل، ولتوسيع نطاق الحوار الثقافي، وأصحبت السينما الخليجية، بمغامراتها وتناقضاتها وتنوّعها، بدأت ترسم لنفسها موقعًا على الخارطة الدولية ليس بوصفها ظاهرة عابرة، بل كصوت قادم من الجنوب، يستحق الإنصات.